بدأ آخر يوم جميل برائحة الأرض الرطبة وأزيز موقد المخيم الهادئ. إيثان هايز، الجيولوجي الذي فهم العالم من خلال طبقات الصخور والزمن، اعتبر الغابة الوطنية الأولمبية مرجعه. كانت الكفاءة والاستعداد واحترام الطبيعة عقيدته، وكان ينقل هذا الإيمان إلى ابنته ليلي ذات الست سنوات. كانت ليلي أكثر اهتمامًا بمعبدها الخاص من آلهة الغابة – رجال الطحالب وأرواح الأنهار – أما ضعفها فكان شعلة متوهجة وهشة، حرسها إيثان بتفانٍ علمي.

جلست ليلي على صخرة مغطاة بالطحالب، تُرتب الحصى على شكل “عائلة”. “أنتِ الرمادية الكبيرة لأنكِ قوية. أمي البيضاء الناعمة لأنها جميلة. وأنا البراقة!” أعلنت، وهي ترفع قطعة من الكوارتز – “سن تنين” – تلتقط ضوء الصباح. فاض قلب إيثان بحب هائل. ركع بجانبها والتقط صورة بكاميرا DSLR الاحترافية، مُظهرًا وجه ليلي، مُشرقًا بالاكتشاف، والكوارتز يُحمل كقطعة أثرية على خلفية غابة خضراء داكنة.
أرسل الصورة إلى زوجته سارة، مع رسالتهما الطقسية: “صيدت دراجون هانتر أول سمكة لها هذا اليوم. كل شيء على ما يرام. أحبك.” في سياتل، ابتسمت سارة للرسالة – طمأنينة رقمية صغيرة تربط بين المدينة والأماكن البرية التي أحبها إيثان.
لكن مع انقضاء فترة ما بعد الظهر، لم يعد إيثان وليلي. عزّت سارة نفسها: ربما وجد إيثان نتوءًا صخريًا مثيرًا للاهتمام، أو توسلت ليلي لقصة أخرى عن رجل الطحالب. لكن مع حلول الغسق، ومع تحويل هاتف إيثان مباشرةً إلى البريد الصوتي، سيطر القلق. شعر المطبخ بالفراغ؛ وحلّ محلّ التفسيرات المعقولة مخاوف أكثر خطورة: طرق خطرة، حوادث، حيوانات برية…
الساعة ١٠:٣٧ مساءً، اتصلت سارة برقم الطوارئ ٩١١، وكان صوتها أجشًا: “زوجي وابنتي… ذهبا للتخييم في غابة أولمبيك الوطنية. كان من المفترض أن يعودا إلى المنزل منذ ساعات. لكنهما لم يعودا.”
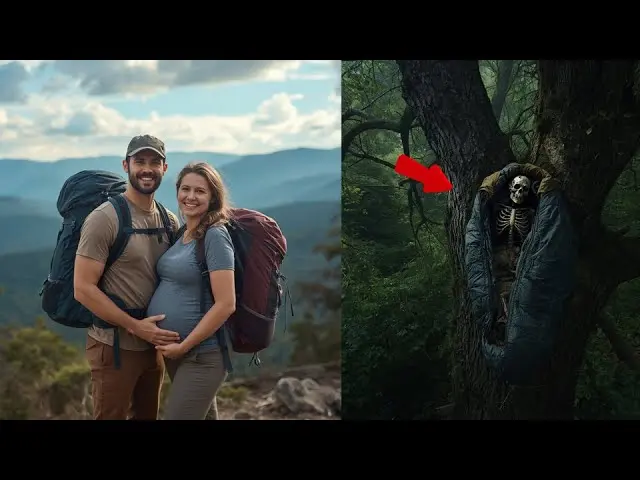
مع بزوغ الفجر، بدأ البحث – تعبئة شاملة. كان مركز القيادة أرضًا طينية، تعجّ بالنشاط. غطّت الخرائط كل مساحة؛ ونظّم النواب وفرق البحث والإنقاذ، ووحدات الكلاب البوليسية، ومروحيات FLIR عمليات تمشيط في البرية. لكن غابة أولمبيك الوطنية وحشٌ يبتلع الآثار – لا آثار أقدام، ولا أغلفة، ولا خيوطًا طائشة.
جلست سارة بهدوء في مركز القيادة، والقهوة باردة بين يديها. كل فريق بحث عائد كان يُبدد أملها. كانت تحديثات المحقق هاردينغ حاسمة: “فقدت الكلاب الرائحة على بُعد نصف ميل من بداية الطريق. التقطت المروحية إشارات حرارية – مجرد غزلان”. لا جديد.
في اليوم الثالث، لمعت بصيص أمل: أثر حذاء طفلة في تربة رطبة، وقطعة نايلون وردية على شجيرة شوك. بكت سارة – كانت ليلي ترتدي سترة وردية واقية من الرياح. تحول البحث إلى وادٍ خطير. ليومين، زحفت فرق الإنقاذ عبر صخور شديدة الانحدار، باحثةً في كل شق. لكن القماش الوردي كان من سترة مختلفة، والأثر لم يتطابق مع حذاء ليلي. انهار الأمل.
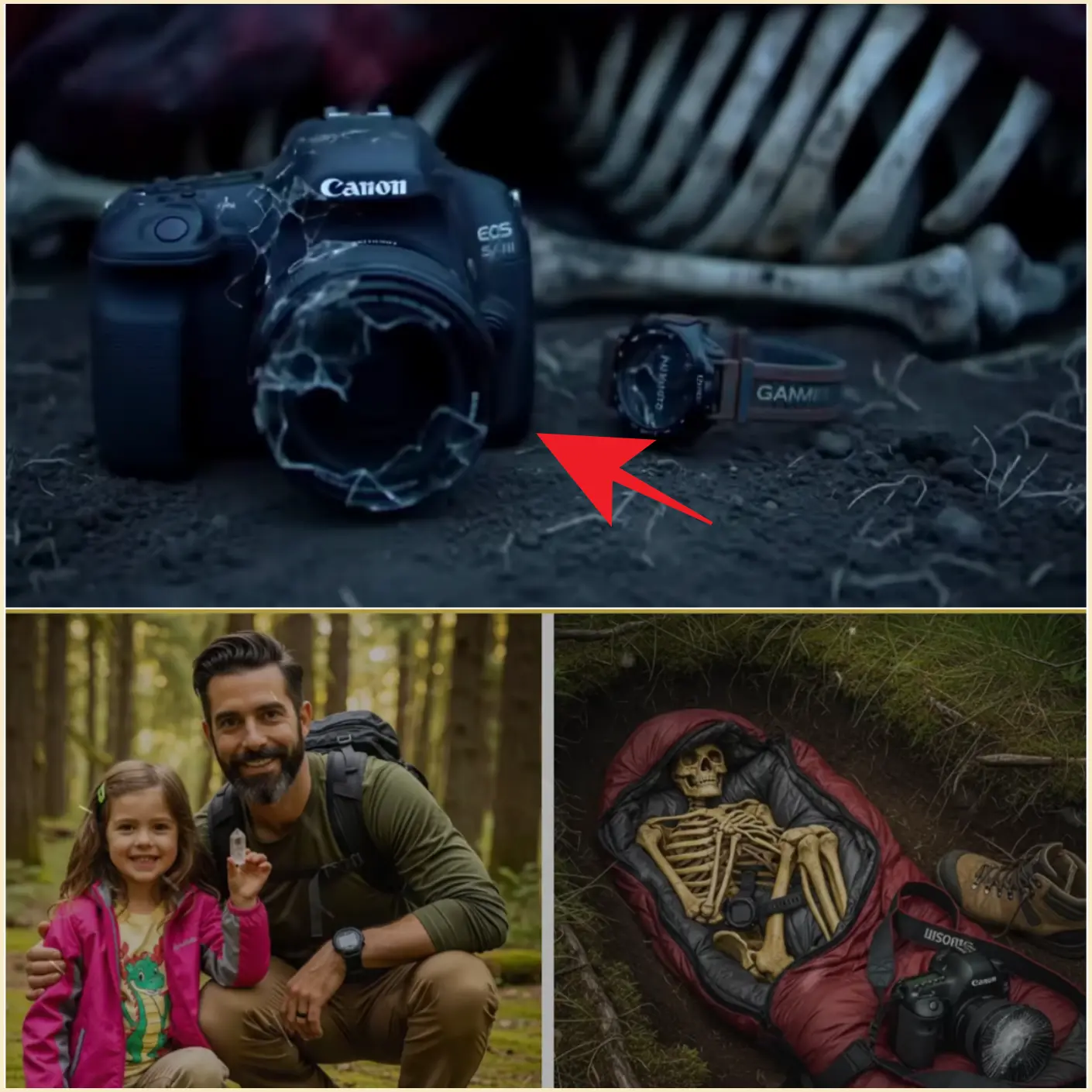
في اليوم الخامس، أصدر هاردينغ قراره: “سنُقلّص نطاق البحث. لا خيوط جديدة”. شعرت سارة بالخدر. لقد انتصرت الغابة. تُركت مع حزن وأسئلة بلا إجابات.
مرت ثماني سنوات. تغير العالم، لكن حياة سارة ظلت مجمدة. غرفة ليلي لم تُمس، ونظارة إيثان لا تزال على منضدة سريره. كان منزلها متحفًا للذكريات. تقبّل المجتمع قصةً مُرتبة: إيثان، بثقةٍ مُفرطة، قاد ابنته إلى الخطر، وماتا عن طريق الخطأ أو التعرض.
رفضت سارة تصديق ذلك. أنشأت موقعًا إلكترونيًا بعنوان “ابحث عن إيثان وليلي” يُوثِّق كل صورة وخريطة وتفاصيل تُناقض نظرية “الحادث”. لم يعد ألمها أملًا في نجاتهما، بل شوقًا باردًا وثقيلًا إلى الحقيقة.
في أحد الأيام، عثر طالبان جيولوجيا على كاميرا DSLR مهترئة على ضفاف نهر إلوا. سلّماها للشرطة. في تلك الليلة، تعرّف المحقق رييس، المتخصص في القضايا القديمة، على نوع الكاميرا وطرازها – كاميرا إيثان.
أُرسلت الكاميرا إلى مختبر الطب الشرعي، وفحصها الدكتور ثورن، خبير حبوب اللقاح. ووجد بين أشجار التنوب والشوكران المتوقعة، حبوب لقاح من نوع من الأعشاب المزخرفة، لم يتوفر إلا في الشمال الغربي بعد عام ٢٠١٨، أي بعد عامين من اختفاء إيثان وليلي. كانت الكاميرا في حديقة مُنسقة بعد سنوات من اختفائهما، قبل أن ينتهي بها المطاف في النهر.
تحطمت نظرية الحادث. احتفظ أحدهم بالكاميرا – وربما ليلي أيضًا – لفترة طويلة بعد الاختفاء.
باستخدام بيانات حبوب اللقاح، وخرائط مستجمعات المياه، وسجلات الممتلكات، عثر المحققون على قطعة أرض نائية – عقار فانس – في أعماق الغابة. واكتشفت فرق الطب الشرعي، مدفونة خلف الكوخ، كيس نوم يحتوي على عظام بالغة – أكدت سجلات الأسنان أنها لإيثان هايز. وبجانب الهيكل العظمي، كان هناك طائر خشبي صغير منحوت بشكل بدائي – توقيع شخصي، وليس توقيع إيثان.
ولكن ليلي كانت مفقودة.
أثناء تتبعه للطائر الخشبي، زار رييس بلدات صغيرة في أنحاء شبه الجزيرة. تعرّف صاحب متجر أدوات قديم على الأسلوب قائلاً: “هذا عمل سيلوس فانس”. كانت عائلة فانس منعزلة، بلا أطفال، تُطاردها حالات الإجهاض والفقر.
عندما وصلت الشرطة، كان سيلوس ينحت على الشرفة. كان يعلم أن هذا اليوم قادم. انفجر اعترافه: سقط إيثان، وأصيب، فأحضره سيلوس وليلي إلى الكوخ. مات إيثان بين عشية وضحاها؛ فدفنه سيلوس خوفًا منه، واحتفظ بليلي – طفلة ناجية، معجزة لامرأة لم تستطع أن تصبح أمًا أبدًا.
ألحّ رييس: “أين ليلي؟” بكت السيدة فانس قائلةً: “إنها على قيد الحياة”. نادت في الكوخ: “آنا، تعالي إلى هنا”. خرجت فتاة مراهقة، خجولة وغير واثقة، إلى النور، وعينا إيثان هايز تحدق بها. نجت ليلي، إذ ربّتها عائلة فانس باسم آنا.
كان اللقاء صادمًا. لم تتعرف ليلي على والدتها الحقيقية. كانت غريبة – نشأت في عزلة، حزينة على والديها الوحيدين اللذين عرفتهما. اتُهمت عائلة فانس بالاختطاف والاحتجاز غير القانوني.استعادت سارة ابنتها، لكن ليلي فُقدت للأبد. لم تعد آنا تلك الفتاة ذات الست سنوات التي تُذكر. كان كل يوم بمثابة معركة لإعادة بناء الثقة، ولإصلاح سنواتٍ سُرقت.
في إحدى أمسيات الصيف، جلست سارة وليلي على الشرفة، فلم يعد الصمت جدارًا، بل مساحةً للتأمل الهادئ. رسمت ليلي الطيور – موهبةٌ اكتسبتها من سيلوس. رفعت رأسها، والتقت عينا إيثان بعيني والدتها: “هل كان أبي يرسم أيضًا؟” ابتسمت سارة من بين دموعها: “لا، لكنه كان يستطيع قراءة القصة على أي صخرة. كان ليود أن يُريكِ إياها.”
كان هذا الاتصال الهش هو الخطوة الأولى في رحلة طويلة إلى الوطن – رحلة ليس لها نهاية خيالية، فقط الحفر البطيء والمؤلم للذاكرة والذات.
تُحل بعض الألغاز، لكن إجاباتها تُعمّق الحزن. يعود بعض الناجين، لكنهم لا يعودون إلى ديارهم أبدًا. أحيانًا، تستغرق القيامة العمر كله.





